الشيخ عبد الغني النابلسي
عبد الغني النابلسي الدمشقي: شاعر، وفقيه، ورحَّالة، ومتصوِّف سوري، يرجع نسَبُه إلى «عمر بن الخطاب».
وُلد «عبد الغني النابلسي» في دمشق عام ١٦٤١م في بيتِ عِلم؛ فقد كان جدُّه مدرِّسًا لجامع «درويش باشا» وناظرًا لوَقْفه، وقد تَولى أبوه المهامَّ نفسَها بعد وفاة جدِّه. كان أبوه أولَ معلِّم له؛ فقد حفظ على يدَيه القرآنَ الكريم في سِن الخامسة، وحين بلَغ العاشرة حفظ كثيرًا من المقدِّمات والمنظومات مثل: «ألفية ابن مالك في النحو»، و«الشاطبية في القراءات»، و«الرحبانية في الفرائض»، و«الجَزرية في التجويد»، كما تابَع دروس «نجم الدين الغزي» في الحديث في الجامع الأموي، وحصل على أول إجازة عامة في الحديث.

عمل «النابلسي» مدرسًا في الجامع الأموي وهو في سِن العشرين من عمره، وحين بلغ الخامسةَ والعشرين ارتحل إلى أدرنة بالدولة العثمانية ثم زار إسطنبول، وبعد عودته عُيِّن قاضيًا في حي الميدان جنوب دمشق، لكنه استقال من منصبه ليتفرَّغ للتدريس والتأليف.
تَجاوَزت مُؤلَّفاته ثلاثمائة عمل مُوزَّعة بين الشِّعر وأدب الرحلات والفقه والتصوُّف والحديث والتفسير؛ ومن أبرزها: «إيضاح المقصود من وَحْدة الوجود»، و«الوجود الحق والخطاب الصدق»، و«التعبير في تفسير الأحلام»، و«ديوان الدواوين» وهو مجموعُ شِعره، و«أسرار الشريعة»، و«الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية»، و«ذخائر المواريث في الدلالة على مَواضع الحديث»، وغير ذلك من المصنَّفات الغنية التي تُعَد مصادرَ مهمة في مجالاتها.
اشتهر بالتصوُّف ومُجاهَدة النفس حتى وصل إلى مرتبة العارفين، وكان يَتبنى أفكارَ «محيي الدين بن عربي» ويُدافِع عنه ضدَّ مُنتقِديه، ودخَل في معركة حامية مع علماء وفقهاء عصره حول أفكاره الصوفية والقول بوَحْدة الوجود، وتَعرَّض على إثرها لأزمةٍ نفسية حادة في سن الأربعين، اضطرَّ على إثرها إلى الاعتزال في بيته لمدة سبع سنوات، قضاها في التأليف والتدريس، وأسدَل شَعره في أثنائها، وأرخى لحيتَه، وطلَّق زوجته، لكنه خرج بعدها إلى الناس الذين ازداد احترامُهم له بعدَ أن كانوا قد رمَوه بالحجارة قبل خلوته.
تُوفِّي «النابلسي» عام ١٧٣١م في دمشق، ودُفِن بالقبة التي بناها في بيته، والتي أُقيم عليها جامعٌ بعد ذلك.
كَرِهَ الحشيش وعشِقَ القهوة والتنباك.. العارفُ الدمشقيّ عبد الغني النابلسي من العزلة إلى أدب الرحلة
راق لي من موقع رصيف 22 للسيد وسام سعادة النص التالي حرفيا
“ثم دخلنا إلى بيروتَ المحروسة، ذاتِ الربوع المأنوسة، وحصل لنا غايةُ الإكرام والسرور التام”. صورةٌ لم تعدْ مألوفةً لنا أبداً، عن مدينة بيروت أواخرَ القرن السابع عشر، تحفظها لنا كتبُ الأسفار الشيّقة والمتشعّبة للعارفِ الدمشقيِّ عبد الغني النابلسي (1641-1731)، تظهرُ كمدينةٍ صوفيّةٍ بامتياز. يَكتبُ في “التّحفةِ النابلسية في الرحلة الطرابلسية”: “لقد رأينا في بلدةِ بيروتَ المحميّة، زوايا كثيرةً وجوامعَ وحماماتٍ فلا بأسَ بذكرِ محاسنها السنّية، فمن الزاوية مشرقةِ الأنوار، تسمّى بزاوية ابن القصّار، وهي نيّرةٌ مرتفعةُ البنيان، يجتمعُ فيها الوعَّاظ ما بين العشائين، يتدارسون بها القرآن. ومنها أيضاً زاويةٌ تسمّى بزاوية الحمرا، يُقامُ فيها الذِّكر والأوراد، وبها حفّاظٌ تقرأ، وهي متّسعةٌ، بها إيوانٌ به محرابٌ كبير، وفيها بركةُ ماءٍ بجانبها بئرٌ يستخرج منها ماءٌ غزير”. يخبرنا هذا العالِمُ الدينيّ والعارفُ الصوفيّ الذي يعدّ من أبرز أعلامِ العصرِ العثماني المتأخّر في بلاد الشام، عن بساتين “بيروتَ التي أشجارُها ركعتْ مع النسماتِ ذاتِ صفوف”. قبلَ ذلك يخبرُنا عن مَقام الخضْر في الطريق من نهر الكلبِ نحو بيروت، و”يعتّلنا همّه” عندما يصلُ إلى دير القمر وهو يقول “ولا عجبَ في سياحتنا هذه من مرورنا بالبلادِ الظلمانية، ورؤيتنا لوجوهِ من فيها من المخالفين للملّة الإسلامية”. مهلاً، تفصلُنا أزيدُ من ثلاثةِ قرونٍ على هذا الكلام!
من العزلة والتدريس إلى شدّ الرّحال…
كان النابلسيُّ في الخمسين من عمره حين عقدَ العزمَ على جوْبِ البلدان الشاميّةِ والمصريّةِ والحجازية، في سلسلةِ رحّلاتٍ (ما بين 1688 و1700)، دوّن كلَّ كبيرةٍ وصغيرةٍ رآها أو سمع عنها. قبلَ ذلك لزمَ مدينتَه دمشق، عقوداً طويلةً، صنّف فيها المؤلّفاتِ العديدةَ ودرّس في الجامع الأموي، الفقهَ صباحاً، والتصوّفَ مساءً، واشتهر تحديداً بتدريسه محيي الدين بن عربي، وتصدّيه لحملاتِ التكفير المستعرةِ في الأناضول والأستانة كما في الشام، ضدَّ الشيخ الأكبر. لا يبتعدُ عن هذا المناخِ السجاليِّ الحادّ اضطرارُ النابلسي لعزلةِ سبعِ سنواتٍ متواصلةً في دارتِه بسوق العنبرانية، المواجهةِ للباب القبلي من الجامع الأموي، لا يخرجُ منها. مطلعَ شبابِه، سافرَ إلى العاصمةِ، اسطنبول، ولسببٍ ما آثر عدمَ كتابةِ الرحلة، لكنّه بعد كلّ هذه العقودِ الدمشقية أرادَ أن يسافر مجدّداً، وأن يكتبَ بغزارةٍ وتفصيل. أرادها سلسلةَ زياراتٍ لأضرحةِ أولياء الله الصالحين، الأحياءَ منهم والأموات، يستضيفه خلالَها علماءُ الدين المتقاربِين معه، من منطقةٍ إلى أخرى. نوعٌ فريدٌ من أدبِ الرحلة تتداخلُ فيه أخبارُ مجالسِ الخاصة ولمحاتُ الثقافةِ الشعبية، وتصبح فيه بلدانُ الشرق العربي العثماني خارطةً صوفيةً بامتياز، من المقاماتِ والمزاراتِ والتَّكايا. كانت أسفارُه أيضاً، بمثابة “موقفٍ أيديولوجي” كما هو حالُ عزلتِه سابقاً. في كتاب “الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية” نراهُ يحملُ على ابن تيمية بشدّةٍ: “من جعل شدَّ الرحالِ لزيارة الصالحين معصيةً، ورتّبَ على ذلك عدمَ جوازِ الرخصةِ له في السفر على مذهبِه، فهو مخطىءٌ الخطأَ الفاحش”. يستهجنُ النابلسي كيف جعلَ ابن تيميةَ من “شدَّ الرحالَ إلى بيت المقدس معصيةً”، وكيف نهى عن التوسّل بالنبيّ إلى الله وبغيره من الأولياء، وكيف خالف إجماعَ الأئمة الأربعة في وقوعِ الطلاق بالثلاث بلفظةٍ واحدة “إلى غير ذلك من التهوراتِ الفظيعةِ الموجبةِ لكمال القطيعة”.
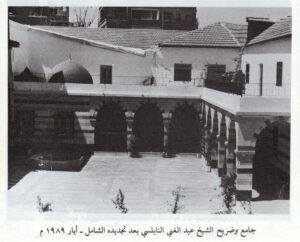
قادريّ ونقشبندي.. “الخلوة في الجلوة”
انتسبَ عبد الغني النابلسي إلى طريقتين في التصوّفِ في وقتٍ واحد، القادريةُ، حين أقامَ عند أهلها في مدينةِ حماةَ، وهو في طريقه إلى اسطنبول مطلعَ شبابه، والنقشبنديةُ، في دمشقَ نفسِها. القادريةُ، نسبةً إلى عبد القادر الجيلاني البغدادي تـ1165 م، تحيي حلقاتِ ذِكْر الله جهاراً، وتستخدم فيها الطبولَ الكبيرةَ، والصغيرةَ، والناياتِ، والكاساتِ، أما النقشبنديةُ، أكثرُ طرائقِ الصوفيةِ “تسنّناً” وتقيّداً بآداب الشريعة، فهي تجعلُ من الخليفة أبي بكر الصدّيق رأسَ سلسلتِها، وتسمي نفسَها أيضاً لأجل ذلك بالبكرية. “نقشي بندي” بالفارسي تعني حِرفةَ تطريز الحرير، وسبب التسمية عند النابلسي “إثبات نقشِ التوحيدِ في لوحِ القلب وتحقيقُ القلب به وإدامةُ استحضارِه بحيث لا ينفكُّ عنه”. بخلاف القادريةِ، تشدّدُ النقشبنديةُ على ذِكر الله بصمتٍ وسكينةٍ، “الذكر الجهريّ”، ويتعلّم المريدُ فيها حبسَ النفَسِ خلال عملية الذِّكر. لم يأخذِ النابلسي مع هذا بالنفورِ النقشبندي من الموسيقى، بل اعتنى بوضعِ مصنّفٍ حول الأدواتِ الموسيقية. أما المقولةُ النقشبنديةُ الشهيرة “الخَلوةُ في الجَلوة”، التي تحثُّ مرتادَ الطريقة على مخالطةِ الناس وليس اعتزالَهم، فقد تفاوتَ تقيّدُ النابلسي بها، بين إيثار العزلةِ التّامة خلافاً لها سنينَ طويلةً، وبين الالتزامِ بها في نطاقِ عمله التدريسي بالجامع الأموي، وبين الالتزامِ الشاملِ بها من خلال أسفاره. لا يتركُ مزاراً إلا ويقصدُه، ويبدي اهتماماً بـ”المجاذيب المولَهين” سواء الذين يعتزلون الناسَ في مغاور، أو ذاك الرجل الذي يخبرنا عنه “يلبس ثياباً طوالاً تكنسُ الأرضَ، ولا يلتفتُ إلى أحدٍ، يأوي إلى المزابل، والناس يعتقدون فيه الصلاحَ، ويحكون عنه عجائبَ وغرائب”. يميلُ في المقابل، خصوصاً في مصر، إلى استهجان رقصةِ “الهوية” (من هو، هو، هو، في إشارةٍ إلى الله) عند الطرق الدمرداشية، والخَلوتية، والشِّناوية، وشيوعِ الحشيشِ في هذه الطرق.
القهوة شرابُ أهل الله
بقَدرِ نفورِ النابلسي من الحشيش، كان طليعياً في معركة “القهوة والتنباك” ضدَّ من ارتأى تحريمهما في عصره. فتراه ينظِمُ في كتابه “خمرة بابل وغناء البلابل”: “زوجُ القهوةِ للتنباك تنجَلِي بينَ يدِ النَّساك” أما في أدبِ رحلتِه فيمكنكَ أن تقرأ: “عرّج على القهوة في حانِها فاللطفُ قد حفَّ بندمَانِها شرابُ أهلِ الله فيا التقى جوابُ من يسألُ عن شانِها” بل أنّه، وعلى غرار “التصوّف الخمري” عند ابن الفارض، يحاصركَ النابلسي بنوعٍ من “قهوة العشق الإلهي”: “وقهوةٌ بنية تُجتلى ونفعُها الأكبرُ لا يُجحَدُ جامعةٌ للقوم أهلَ الوفا مانعةٌ النومِ لمن يعبدُ كأنها والمسكُ في لونِها والمَندَلُ الرّطبُ به توقدُ قد ذابَ فيها الليلُ من طوله أو حُلّ فيها الحجرُ الأسود”.
لولا أن في الدخّان سّراً..
ويستجمعُ في كتابِ رحلته الكبرى “الحقيقةُ والمجاز في الرحلة إلى بلادِ الشّام ومصر والحجاز” بعضاً من قصائدٍ استقاها من مجالسِ تلك الأيّام، في معشرِ المتصدِّين مثله لتحريمِ القهوة والتدخين. تبدو هذه القصائدُ لنا اليوم، بمثابة “دعاية مضادة” لذهنية “أن وزارةَ الصحة تحذّرُك من مضار التدخين”. فهذه واحدة مثلاً، يقتبسها من إقامته بمدينة نابلس، يستهلّها السائلُ متهكّماً: “ما قولُكم سادتي في بدعةٍ ظهرت فيا لها بدعةٌ تدعو إلى النار مثل الغمامةِ في العينَين واشتهرت بعد الخفاءِ بغليونٍ كمزمارِ هل جائزٌ شربُها فينا فقد كثرت وقيل قد ظهرتْ من عند كفارِ؟” ثم يجيب القسمُ التالي من القصيدة، مستعرضاً منافعَ التدخين: “وبدعةٌ قلتُ لكن بعضَهم شهدوا بأن في شربِها دفعاً لأضرارِ وكالغمامة في العينَين قلتُ فما كلُّ الطبائعِ شكلٌ واحدٌ طاري كن ناظراً قد جلَتْ عنه غشاوتُه وصارَ جوهرةً عن شبهةِ عاري وقد أكبَّ عليها الناسُ واشتهرت أُثبتَ فضلاً لها من نصِّ مختار لا تجتمع أمتي فيما تضلُّ به فكنْ مع الجمعِ فيما يرتضي الباري”. وفي قصيدةٍ أخرى: “جهولٌ منكرُ الدخان أحمقُ عديمُ الذوقِ بالحيوان ملحقُ مليحٌ ما به شيء حرام ومن أبدى الخلافَ فقد تزندقَ ألا أيُّها الصوفيُّ مَيلاً إلى الدخان علّك أن توفقَ ولولا أن في الدخان سرّاً لما فاحتْ روائحه وعبقَ ففي الدّخان سرُّ الله يبدو”.
الإسلام العثماني.. يمينه ويساره
في كتابه الصادر، بالإنكليزية “عبد الغني النابلسي. الإسلام والتنوير” يلفتُ نظرنا الباحثُ سامر عكّاش إلى اختلافٍ أساسيٍّ بين النابلسي وباقي أعلام الصوفية، كونه درسَ التصوّفَ في كتب ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني مطوّلاً في سنواتِ مراهقته وشبابه، قبل أن يتّصل سواءً بمشايخ الطريقتين. مكّنه نهلُه من الكتبِ من نظْم قصيدتِه في مدح النبي الذي استبعد المنكرون أن تكونَ له، فكان عليه أن يمضيَ شهراً كاملاً في شرح معانيها الكامنة. يدرجُ عكاش النابلسي ضمنَ الاتجاه لتوسيعِ حدودِ التسامح وتيسيرِ السُّبل في الإسلام العثماني، شأنَه في ذلك شأن ابراهيم حقي الأرضرومي تـ1781م. على يسار هذا الاتجاه، هناك من يمكن توصيفهم بأعلام “عصر التنوير العثماني” (الجزئي) في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ككوزي ابراهيم وأبو بكر الدمشقي وعثمان بن عبد المنان، المهتمين بتطوير الجغرافيا والهندسة والفلكيات، وحاجي خليفة، كاتب جلبي تـ1657م وابراهيم متفرقة تـ1745م، المهتمين بالوصلِ بين التطوّر العلمي، المحاكِي لبدايةِ الطفرة العلمية الحديثة في أوروبا الغربية وبين الإصلاح الديني وإعادة الغرْفِ من التراثِ الفلسفيّ الإسلامي.

أما على يمين النابلسي والتسامحيةِ العثمانيةِ الصوفية، فسنجد رائدَ التشدّد والحركة المناهضة للتصوّف، خصوصاً لابن عربي، قاضي زاده محمد تـ1635م، وأتباعه المتشدّدين الـ”قاضي زاده ليلر”. ترجمَ قاضي زاده محمد كتبَ ابن تيمية وابن القيّم، قبلَ قرنٍ من ظهورِ الحركة الوهابية. شنّع على مذهبِ وحدةِ الوجود الذي اتهم ابن عربي بأنه يمحو الفارقَ بين الخالق والخلق من خلاله. حرّض ضدّ زيارة القبور وضد الرقص الصوفي. يبدو أنّ النابلسي، في رحلته شاباً إلى اسطنبول، اصطدم ببعض متشدّدي “القاضي زاده ليلر”.
رجعة ابن عربي
من منبر جامع آيا صوفيا، خاضَ قاضي زاده محمد حملتَه التكفيريةَ العاتيةَ على المتصوفة، خاصة ابن عربي، ومن أجل تحريم القهوةِ والتنباك. مثّلتْ حركته الناقمةُ ارتداداً شاملاً على النهج الذي أرساه السلطان سليم خان “ياوز”، الفاتح العثماني للبلاد العربية ومقوِّض السلطنة المملوكية. أوّلُ ما فعله سليم الأوّل بعد فتحِ دمشقَ كان العروجُ على قبر ابن عربي في الصالحية، والأمرُ ببناء أول مسجدٍ عثمانيٍّ على أرضٍ عربية حوله.
ويروَى أنّ ابن عربي أتاه في المنام وأنبأَه بفتح مصرَ وأن العثمانيةَ هي دولة الإسلام الأخيرة حتى قيام الساعة، لكن الأهم أنّ الفقيه المقرّب من سليم الأول، وأيديولوجي الدولةِ بامتياز في مرحلة صراعِها ضدّ الصفوية فالمماليك، استوحى من مبحثِ “الإنسان الكامل” عند المتصوفة، وبخاصة ابن عربي، صورةً مثاليةً عن السلطان العثماني بوصفه التجسيدَ لهذا “الإنسان الكامل”. وأيّاً يكن من شيءٍ، فقد ارتبط تعظيمُ سليم الأول لابن عربي بسياستِه تجاه البلدان العربية، وقد تميَّز المؤرخ السوفياتي نيقولاي ايفانوف بتسليط الضوء على بُعدٍ أساسي فيها، وهو تشوّق شرائح عربية واسعةٍ للحكم العثماني قبل عقودٍ من مجيئه، والاستقطابُ الواضح بين الاستقبال الحماسي لسليم الأول من طرف الفلاحين والتجار والحرفيين في بلاد الشام، في مقابل عداءِ البدو، وفلولِ المماليك، وأعيانِ المدن له، كامتدادٍ لإسناد حركة “الآخيات” الفلاحية الأناضولية للسلطان سليم. بالتوازي، تُبرز الباحثةُ ايليزابيت سيريي في كتابها عن النابلسي “صوفي رؤيوي من دمشق العثمانية” 2005، وجودَ تراثٍ انتظاري، بين الصوفية، لرجعة ابن عربي مجدّداً في دورٍ جديد، ومن دمشق نفسها، وسريان الاعتقاد أنّ النابلسي هو ابن عربي العائد. كتبَ النابلسي رسالةَ “إيضاح المقصود من وحدة الوجود”، ونظَمَ الشِّعرَ أيضاً في شرح المفهوم: “كُن عارفاً بوحدةِ الوجود وقاطعاً بكثرةِ الموجود وميِّزِ الحادثَ من قديم وخلِّصِ الثابتَ من مفقود واحذرْ من التباسِ ما تجلَّى بغيرِه في حالةِ الشهود فوحدةُ الوجودِ في اصطلاحنا كنايةٌ عن رؤيةِ الودود بالحسِّ والذوقِ الصحيحِ الطاهر الطهورُ من شكٍّ ومن جحود لا بخيالِ العقل والفكر وما تأتي به طبائعُ الجلود”. كان النابلسيُّ صوفياً مستنيراً إلى حدٍّ كبير. يفيدنا سامر عكاش أنّ مفهوم “الغيب” عنده لم يعد مجالاً خارجاً عن حدود العقل الإنساني، بل كلُّ ما نجهل أسبابه وما يمكن أن يبطلَ عن كونه غيباً حين نقف على أسبابه. فسّر النابلسي مفهومَ “الغيب” انطلاقاً من مصطلح “الخبء” القرآني، في آية “ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض”. الأمور المختبئة عرضةً لأن تكتشف. ليس هناك حدودٌ ثابتةٌ للغيبِ إذاً، وفي هذا إرهاصٌ تنويريٌّ واضح. لكنه، كما يشرح عكاش أيضاً، إرهاصٌ لم يؤسِّس عليه النابلسي، لأنهُ حافظَ من بعد إعادةِ تفسيرِه لمفهوم الغيب، ودفاعِه عن وحدةِ الوجود، وتصدِّيه لمتشدّدي “القاضي زاده ليلر”، على موقفٍ مغلقٍ يصفُ المعتزلة بـ”شرّ أهل البدع”، ويرفضُ “التطبيع” مع فلسفة الفارابي وابن سينا، بخلاف رحابَةِ حاجي خليفة، كاتبٌ جلبي، في استعادةِ علوم العقل واستئنافها.
كتب غنه أ. اسماعيل مروة في الوطن السورية
الشيخ عبد الغني النابلسي، شاعرٌ هامَ في حب الشام
23 أيلول 2013

الشيخ عبد الغني النابلسي شاعر متصوف عالم رحالة، لم يتوقف عن طلب العلم، ولم يتوقف عن منح طلابه ومريديه، وهو من المتصوفة الذين ذاع صيتهم، وعرفت جلائل أعمالهم، وسارت أعمالهم وكتاباتهم، وفي كل بلد زاره كانت له حكايات وذكريات، شغل بتدوين رحلاته ومشاهداته، فكانت كتبه منارة علمية، وكانت حياته منهج حياة للزاهدين.
رحل إلى مكة، رحل إلى بيت المقدس، فكانت له رحلته القدسية، ومن منطلقه في دمشق الشام، وإلى عودته كان قلمه مدوناً كل لحظة من اللحظات.. وعبد العني النابلسي بقي قلبه معلقاً بشامه التي ولد فيها 1050هـ ونشأ فيها، وجال في كل بلدان الشام، وقصد مصر وزار الحجاز، وبعد كل تطوافه استقر في الشام وبقي فيها حتى توفي فيها ودفن في ثراها 1143هـ بعد أن ملأ الأصقاع كلها علماً ومعرفة، وبعد أن قال أدباً كثيراً، وشعراً عذباً مطبوعاً.
عرف عن الشيخ عبد الغني النابلسي إكثاره من التصنيف، وذلك يعود إلى طبيعة حياته، فهو عالم وحافظ ومتصوف وتفرغ للتدريس والعلم، وتبصرة الناس بأمور دينهم ودنياهم، لذلك كثرت مصنفاته، إضافة إلى حياته المديدة التي استطاع فيها أن يعطي الكثير مما تعلمه، هذا إلى خبرته ومعرفته التي زادت مع الأيام فمكنته أن يقدم الكثير من آرائه.
والشيخ عبد الغني النابلسي عرف كذلك شاعراً، وهو في شعره وإن كان فقيهاً، يبارز الشعراء والأدباء، ولولا تفرغه لشؤون الدين والعمل لكان من أغزر الناس شعراً، وقارئ شعره يجد شعره أقرب إلى الكلام العادي، فقد بلغ تمكنه من الشعر مبلغاً كبيراً، فحين تقرأ شعره تشعر أن كلام الشيخ كله من الشعر، وهذه خصيصة لا تتهيأ للكثيرين، وكتابته النثرية تغصّ بالبلاغة ومحسناتها، وهو بذلك ابن عصره، ولكنه خرج من إطار المحسنات الممجوجة، ليكون كلامه سهلاً عذباً، ورحلته القدسية خير مثال على نثره
وفي رحلاته وكتبه حفظ لنا الشيخ النابلسي الكثير من الشعر والأدب والمواقع لم نكن نعرف عنها لولا ما حفظه الشيخ الجليل.
أما الشام المكان والمواقع والزيارات والفضائل فهي عند الشيخ النابلسي أمر غير قابل للجدال والنقاش، وأخص وقفتي معه شعرياً في إجلاله للشام كما جاء في «البرق المتألق في محاسن جلق» من تأليف محمد بن مصطفى ابن الراعي الدمشقي بتحقيق الأستاذ الفاضل محمد أديب الجادر.. ومن عيون شعر النابلسي في الشام قافيته على الكامل التي يقرأ فيها مواقع الشام مسبغاً عليها ما تستحقه من إجلال وتقديس، وها هو يخاطب السامع:
إن سامك الخطب المهول فأقلقا
أنزل بأرض الشام واسكن جلقا
تجد المرام بها وكل منال بل
وترى بها عزاً وتفصح منطقا
بلد سمت بين البلاد محاسناً
ونمت بهاء واستزادت رونقا
لا ينبغي حث الركاب لغيرها
هام الفؤاد بحسنها وتعلقا
وفي إشارة إلى قداستها وكثرة مواقعها:
حسبي وآويناها فضلاً لها
قد جاء في القرآن ذاك محققا
إن تعشقوا وطناً فذا أولى لكم
دون البلاد بأن تحب وتعشقا
وعن حسن طبيعتها يقول النابلسي:
يا حسن واديها وطيب شميمه
قد فاح عرف الزهر فيه وعبقا
وتراسلت أطياره بين الربا
سحراً فهيجت القلوب الشيقا
عذبت جداولها فطابت مورداً
تحكي الصوارم صيقلا وتألقا
كيف اتجهت يخر نحوك ماؤه
واليك يركع كل غصن أورقا
وعن معلمي الشام قاسيون والربوة، يقف الشاعر خاشعاً:
والربوة الفيحاء يا نسماتها
مرّي علي ورفرفي عند اللقا
أيام قطع النهر يوصل شملنا
بأحبة ألفوا الخلاعة مطلقا
بالقاسيون مست قلوب أحبتي
ولكم سرى فيه الصبا فترفقا
جبل كثير الخير كلمه الإله
فجال في ذاك اللسان وأنطقا
كم من ولي قد توسد سفحه
بل من نبي حل فيه محققا
وكذلك الشهداء فيه تخالهم
أحياء من عدم البلاء ورزقا
ومغارة الدم والمحاريب التي
للأربعين من الرجال ومن رقا
وأمام الجامع الأموي يقف الشيخ الشاعر ليعد فضائله ومشاهده ومحاسنه فنعرف عنه ما لم نكن نعرف:
وما الجامع الأموي إلا نزهة
منها تراه بالعبادة مشرقا
قد اتقنت صناعة بنيانه
فأتى المزخرف زانه وتأنقا
ولرأس يحيى فيه نور مهابة
ما بين هاتيك السواري أشرقا
وترى دروس العلم فيه دائماً
في كل فن من تداوله رقا
وثلاث هاتيك المآذن تنجلي
مثل العرائس قد لبسن اليلمقا
من فوقها أهل الأذان تراسلوا
بترنم يشجي الفؤاد الشيقا
وفي قصيدة أخرى يتغنى النابلسي بدمشق وحياته فيها، وفي مختلف المناسبات:
يا حبذا جلق من بلدة
اليمن للأمن بها قد تلا
لم أنس بالنيروز يوماً مضى
بالمرجة الفيحاء ذات الكلا
يا سفحة الوادي سقاك الحيا
كم فيك من يوم لنا قد خلا
بالنيربين القلب أودعته
يشم من تلك الربا الشمألا
والربوة الربوة كم لي بها
من مجلس للبال قد بلبلا
بمهد عيسى القلب مهدته
فاستتمم الأفراح واستكملا
تكفل الرحمن للمصطفى
بأهلها من نازلات البلا
ومن قصيدة له في دمشق:
وقد عطفت بالنيرين حديقة
علينا فمنها نحن في جنة الخلد
وأرشفنا الجريال جدول مائها
وفيها لنا قد عطرت نسمة الورد
وهبت صباً في قاسيون فحركت
صبابة قلب قلبته يد البعد
وشط يزيد زاد قلبي تولعاً
بمن شط عني والأضالع في وقد
وها هو يذكر الشام ويتشوق إليها وهو مقيم في بلاد الروم:
حدثوني عن نسمة الأسحار
وغناء الطيور في الأشجار
حب النيربين والمرجة
الفيحاء لما تفوح بالأزهار
وخرير المياه بين غصون
خافضات الرؤوس بالأثمار
وصفوا لي دمشق إني مشوق
لحماها وطيب تلك الديار
بلد آمن وربّ جواد
ببلوغ الأوطان والأوطار
وعلى ساكني دمشق سلام
من طريح بالروم نهب القفار
بعيداً عن علومه الدينية والصوفية والتدريسية يقف الشاعر عبد الغني النابلسي شاعراً من الطراز الفريد، ومنتمياً إلى الشام كما يجب أن يكون الانتماء، ومؤمناً بالشام ومكانتها وقداستها وحفظها ومواقعها، وما كان لهذا الشعر أن يكون لولا إيمان ومعرفة الشاعر، وهو بذلك يعطينا المثال الحي على حب الأوطان والتشبث بها وبمحاسنها، وهو من غربته كان دائم الحنين لكل من في الشام من محاسن، بل ويرى كل حسن فيها، وفيما عداها لا حسن ولا جمال. إنها صوفية الانسان المستحيلة تجاه أرضه ومدينته ووطنه، لذلك حق للنابلسي أن يسكن تربة الشام وصالحيتها، وحق له أن يحتفى به وبعلمه وشعره في دمشق، لأنه الذي دار الأرض وعاد إلى الأرض التي خرج منها، فيها ولد ولها عشق، ولها نظم شعره مستقراً ومسافراً.
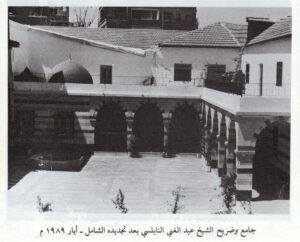
مصادر
- مؤسسة هنداوي
- رصيف 22
- اكتشف سورية
