صفحات مطوية من كتاب جوستاف لوبون «حضارة العرب»
اكتسب كتاب «حضارة العرب» للمستشرق والعالم الفرنسي جوستاف لوبون (1841– 1931م) سمعة طيبة وشهرة واسعة، وبخاصة بين العرب والمسلمين؛ لما احتواه الكتاب من ثناء عاطر على الحضارة العربية، واعتراف شجاع بفضلها على البشرية عامة، وأوربة خاصة. والكتاب، على الرغم من حسناته التي لا تُنكر، فإنه لم يخلُ من هفوات عديدة وزلات شنيعة، وأغلبها تتصل بفهم لوبون للعقيدة الإسلامية وموقفه منها، ومن القرآن، ومن شخصية النبي محمد. لذا، فإن الهدف الذي نسعى إليه هو تسليط الضوء على بعض مواطن الخلل التي وردت في الكتاب، ثم الرد عليها. وتتجلى أهمية هذه المقالة في تبصير القارئ بما في الكتاب من المثالب والمطاعن، وتنبيه الغافل عنها، حتى لا يقع في شراكها وينخدع ببريقها لمصادمتها العقيدة الإسلامية في بعض الأحيان، ومخالفتها الحقيقة التاريخية في بعضها الآخر، مع كامل التقدير لجوستاف لوبون والامتنان له لجميل موقفه من العرب وإعجابه بحضارتهم.
الوقفة الأولى
يقول لوبون في مقدمة كتابه: «حقًّا إن من أعاجيب التاريخ أن يلبي نداء ذلك المتهوس الشهير شعب جامح شديد الشكيمة لم يقدر على قهره فاتح، وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدول وألا يزال يُمسك وهو في جدثه، ملايين من الناس تحت لواء شرعه»(١). إن وصف لوبون للنبي محمد بالمتهوس، وهي الصفة التي سوف نراه يصرّ على إلصاقها بنبي الإسلام في مواضع أخرى من كتابه(٢)، لا تليق بخير البشر، ولا يقبلها من كان في قلبه ذرة إيمان. إن كلمة (هوس) كما عرّفها صاحب مختار الصحاح: طرف من الجنون(٣)، وهو ما نجده كذلك في معجم الرائد الذي عرّف الكلمة بأنها: طرف من الجنون وخفة العقل، فيقال: برأسه هَوَس: أي دوي(٤).
وعلى ما يبدو، فإن لوبون اختار هذه الصفة لموقفه من ظاهرة الوحي، والحالة التي كانت تعتري محمد في أثناء تلقيه الوحي. جاء في الحديث عن عائشة بنت أبي بكر أنها قالت: «إن الحارث بن هشام سأل الرسول: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدها علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي المَلك رجلًا ليكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الملك في اليوم الشديد البرد فيفصم منه وإن جبينه ليفصد عرقًا»(٥). ولا نجد غرابة في أن ينكر لوبون، ومن سار على نهجه، نزول الوحي من عند الله على رسوله، ومن ثم إرجاع ما ينتاب الرسول من تصرفات إلى إصابته بالصرع. ولو أن الرسول كان مصابًا بالصرع لكان قد فقد وعيه ونسي ما أُنزل عليه كما يحصل للمصروع، ولكنه كان يذكر بدقة ما يتلقاه من جبريل فيتلوه على أصحابه من دون زيادة أو نقصان. وعمومًا، فإن الرد على لوبون، ومن سار على مذهبه، يعوزه كلام أكثر ووقفة أطول، والحمد لله الذي قيّض من أبناء الإسلام من انبرى للدفاع عن دينه ونبيه، فألفوا في ذلك مقالات(٦).
الوقفة الثانية
كتب لوبون في ختام الباب الأول البيئة والعرق: «والحق أن وقت جمع العرب على دين واحد كان قد حلّ، وهذا ما عرفه محمد، وفي الوجه الذي عرفه فيه سر قوته، وهو الذي لم يفكر قط في إقامة دين جديد خلافًا لما يقال أحيانًا، وهو الذي أنبأ الناس بأن الإله الواحد هو إله باني الكعبة، أي إله إبراهيم الذي كان العرب يجلّونه ويعظّمونه. وعلائم اتجاه العرب أيام ظهور محمد إلى الوحدة السياسية والدينية كثيرة، وما حدث من الثورة على الأوثان في عهد قياصرة الرومان حدث مثله في جزيرة العرب حيث ضعفت المعتقدات القديمة، وفقدت الأصنام نفوذها، ودبَّ الهرم في آلهتها»(٧).
تدل الجملة الأولى على أن لوبون مؤمن بأن محمد قد اخترع للعرب هذا الدين ليوحد به كلمتهم ويجمع به شملهم! ولا عجب أن يأتي لوبون بهذا الاستنتاج ما دام أنه أنكر ظاهرة الوحي جملة وتفصيلًا، ووصفه بالمتهوس، كما تقدم معنا آنفًا. وأما الجملة الأخرى، فتشير بلا مراء إلى أنه لو لم يأتِ الرسول إلى قومه بدين الإسلام، فإن الأمور كانت تتجه تدريجيًّا نحو تخلي العرب عن عبادة أوثانهم وانصهارهم في بوتقة سياسية ودينية. هذا الرأي –إذا أخذنا به– فإننا نصف بذلك الإسلام بأنه تحصيل حاصل. ولو صحَّ أن بوادر الوحدة العربية المزعومة كانت تتشكل في رحم المستقبل القريب، فما الذي جعل قبائل العرب عامة وقريشًا خاصة تناصب الدين الجديد العداء؟! ثم، من قال: إن علائم الوحدة العربية كانت تلوح في الأفق قبيل بزوغ شمس الدعوة؟ لقد جاء الإسلام والانقسامات مضطرمة والعداوات قائمة، فألّفَ بين قلوبهم، وربطهم برابطة الدين التي تسمو فوق أي رابطة. ومما يدلل على أن العرب لم يعرفوا تلك الوحدة التي يحدثنا عنها لوبون، أن تلك العصبيات والانقسامات بين العرب سرعان ما أخرجت خطمها وعينها حتى قبل أن يُوارى الرسول الكريم في الثرى.
الوقفة الثالثة
في حديثه عن السنوات المبكرة من حياة الرسول عرّج لوبون إلى قصة لقاء نبي الله بالراهب بحيرى مرتين، فقال: «وتقول القصة: إن محمدًا سافر مع عمه إلى سورية مرة، وتعرف في بصرى براهب نسطوري في دير نصراني، وتلقى منه التوراة»، «وتهيأ له السفر إلى سورية بذلك، والاجتماع مرة ثانية بالراهب الذي أطلعه على علم التوراة سابقًا»(٨). إن هذا الخبر متهافت، ولا يصمد أمام التحليل، ويبدو لي أن لوبون نقله من غيره من دون تمحيص وفَحْص. في رحلته الأولى إلى الشام، وكانت بصحبة عمه أبي طالب، كان محمد طفلًا صغيرًا لا يتجاوز التاسعة من العمر. وتحدثنا كتب السير والتواريخ عن حوار دار بين الراهب بحيرى وأبي طالب، وليس ابن أخيه.
ولو سلّمنا أن بحيرى اجتمع بمحمد، فلماذا أخذ يحدثه عن التوراة بدلًا من أن يحدثه عن الإنجيل، وهو الراهب النسطوري؟! ولو سلّمنا مرة أخرى أن بحيرى حدّث عن التوراة، فلماذا وقع اختياره على هذا الصغير دون غيره من الرجال الذين كانوا في القافلة؟! ألا يدل هذا على أن بحيرى قرأ أمائر النبوة في ابن التاسعة ربيعًا؟! ثم، ما الهدف من تأكيد لوبون وغيره من المستشرقين هذا اللقاءَ المزعوم؟ أيقصدون بذلك أن تعاليم الإسلام ومعتقداته تحمل بصمات العهد القديم، أي التوراة؟ وهل تكفي بحيرى ساعة، أو بضع ساعات، حتى يغرس في عقل طفل في التاسعة من عمره ما جاء في التوراة؟!
أما اللقاء الثاني الذي أشار إليه لوبون، فلا نجد له أثرًا في المصادر الإسلامية. حتى لو قبلنا أن الرسول نزل ضيفًا على بحيرى في ديره، فلماذا لم يقتبس الإسلام من النصرانية أصول العقيدة ويتبنى تصوراتها للمسيح عليه السلام؟!
الوقفة الرابعة
وصف لوبون ما جرى في أعقاب صلح الحديبية مع قريش في السنة السادسة من الهجرة، فكتب: «رأى محمد بعد ذلك الإخفاق أن يروّح أصحابه، فخف بهم إلى مدينة خيبر المحصنة المهمة الواقعة في شمال المدينة الغربي، والبعيدة منها مسيرة خمسة أيام، والتي كان يقطن فيها قبائل يهودية، والتي كانت مقر تجارة اليهود، ففتحها عنوة…»(٩).
لم يكن صلح الحديبية إخفاقًا كما ذهب لوبون، بل كان فتحًا عظيمًا ونصرًا مؤزرًا؛ فشروط الصلح في الظاهر تشعرك بأنها كانت ضيمًا وهضمًا للمسلمين، ولكنها في باطنها كانت عزًّا وفتحًا مبينًا على الإسلام والمسلمين. يقول البراء بن عازب: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحًا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، يوم الحديبية…»(١٠). إن من أعظم ثمرات هذا الصلح أن تفرغ المسلمون لبث الدعوة ونشرها بين قبائل العرب، فدخلت في دين الله أعداد كبيرة حتى من أهل مكة. أما مقولة لوبون: إن محمد انعطف إلى خيبر بُغية «أن يروّح أصحابه» فإنها زلة لا تليق بمقام لوبون، ولا بما عُرف عنه من الحياد والإنصاف. فمنذ متى كان يرفه عن أصحابه بقتال الآخرين؟! إن تسلية النفس بهذه الطريقة سلوك لا يصدر إلا من عصابة لا يهذبها مبدأ ولا يحكمها قانون. إن نبي الله لم يقصد خيبرَ إلا بعد أن جعلتْ نفسَها وكرًا للدسائس والتآمر، ومعدنًا للتحرشات وإثارة الحروب، فأهل خيبر هم من حزّبوا الأحزاب ضد المسلمين، وألّبوا أصحابهم من بني قريظة على الغدر والخيانة في غزوة الخندق(١١).
الوقفة الخامسة
وعن فتح مكة قال لوبون: «ولما أحسَّ محمد نمو سلطانه عزم على فتح مكة، وألّف جيشًا من عشرة آلاف محارب، أي ألّف جيشًا لم يسبق أن جمع مثله، وبلغ محمد أسوار مكة، وفتحها به من غير قتال، وذلك بقوة ما تم له من النفوذ»(١٢). العبارة على قصرها مثقلة بأخطاء فادحة. فالرسول لم يحشد كل هذا العدد الكبير لأنه كان يسعى إلى توسيع رقعة سلطانه، وإنما حشده لأن أهل مكة نقضوا صلح الحديبية، وهو ما تتفق عليه المصادر الإسلامية المعتبرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن لوبون لم يوفق في استعماله لكلمتي (سلطان) أو (نفوذ)؛ فالنبي لم يكن طالب ملك، ولا خطر حب الدنيا له على بال، فقد عاش حياة الزهد والعبادة، وانشغل بأمر الدعوة وهمّ الآخرة، وسيرته وأحاديثه ناطقة بذلك. إن حديث لوبون عن السلطان والنفوذ يذكرني بما قاله أبو سفيان للعباس بن عبدالمطلب، حين رأى الرسول في جموع المهاجرين والأنصار يسير بهم إلى فتح مكة: «لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمًا، فقال له العباس: ويلك يا أبا سفيان إنها النبوة، فقال: نعم»(١٣). أما مقولة لوبون: «وبلغ محمد أسوار مكة»، فلا نعرف حقًّا من أين جاء لوبون بتلك الأسوار؛ إذ إن مكة لم تكن حين دخلها المسلمون محاطة بأي نوع من الأسوار!
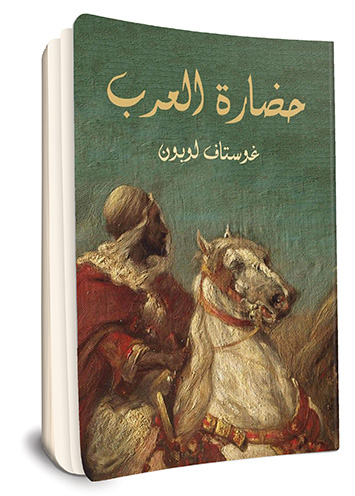 الوقفة السادسة
الوقفة السادسة
وفي حديث لوبون عن القرآن الكريم كتب قائلًا: «القرآن هو كتاب المسلمين المقدس، ودستورهم الديني والمدني والسياسي الناظم لسيرهم، وهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع أنه أُنزل وحيًا من الله على محمد، وأسلوب هذا الكتاب، وإن كان جديرًا بالذكر أحيانًا، خالٍ من الترتيب فاقد السياق كثيرًا، ويسهل تفسير هذا عند النظر إلى كيفية تأليفه، فهو قد كُتب تبعًا لمقتضيات الزمن بالحقيقة، فإذا ما اعترضَتْ محمدًا معضلةٌ أتاه جبريل بوحي جديد حلًّا لها، ودُوّن ذلك في القرآن»(١٤).
لا عجب في أن يصف لوبون القرآن بقلة الترابط بين آياته وسوره؛ فهذا ما يظنه كل من لا ينفذ إلى ما وراء جدار النص وظاهر القرآن. ولقد سبق لابن العربي (ت: 543هـ/1148م) في «سراج المريدين» أن شكا قلة العناية بهذا الباب من التفسير، فقال: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون الكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله لنا فيه فلمّا لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه»(١٥). ثم أخذ هذا العلم يلقى نصيبه من الاهتمام، فصنّف فخر الدين الرازي (ت: 606هـ/1210م) كتاب «التفسير الكبير»، ثم تبعه أبو الحسن علي الحرالي (ت: 637هـ/1239م) فألّف كتاب «مفتاح الباب المقفل في فهم القرآن المنزل»، وجاء بعده بأكثر من قرنين برهان الدين البقاعي (ت: 885هـ/1480م) فاغترف من الحرالي في تأليفه لكتاب «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»(١٦). فهذه الكتب، وغيرها مما لم نذكرها، تُسقط دعوى لوبون حول تشظي النص القرآني وتداخل آياته وسوره.
كما أن العبارة المذكورة آنفًا لا تخلو من وجود تناقض عجيب ربما لم يفطن لوبون إليه. ففي الوقت الذي ذكر فيه لوبون أن الوحي كان ينزل بالقرآن على محمد، وأنه كلما قابلتْ رسولَ الأمة مشكلةٌ خفَّ إليه جبريل بالحل، نجده في الوقت نفسه يصف القرآن بأنه مُؤَلف وأنه كُتب تبعًا لمقتضيات الزمن، وهي نظرة تجسد موقف لوبون من مسألة الوحي، كما ألمعنا إليها في الوقفة الأولى.
الوقفة السابعة
كتب لوبون وهو يستعرض جملة من آيات القران: «وما جاء في القرآن من نص على خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق آدم، والجنة، وهبوط آدم منها، ويوم الحساب مقتبس من التوراة»(١٧). لماذا يتهم لوبون القرآن بالاستعارة من التوراة وهو من كتب قبلها بصفحتين: «… والحق أن اليهودية والنصرانية والإسلام فروع ثلاثة لأصل واحد، وأنها ذات قربى وشيجة»(١٨)؟! فما دامت الأديان السماوية الثلاثة قد خرجت من مشكاة واحدة، فلماذا إذن يُوصم القرآن وحده بالاقتباس من التوراة؟! ونحن لا نزعم أن الإسلام نسيج جديد ودين فريد؛ فما بينه وبين اليهودية والنصرانية من أواصر قربى لم تكن لتنقطع، ولكن الإسلام قوّم ما اعوج، وصحّح ما اختل عند اليهود والنصارى من المفاهيم والمعتقدات.
إذا كان لوبون يؤمن بأن القرآن قد استمد بعض التصورات والمعتقدات من اليهودية، فما قوله فيما نجده بين الديانتين من تباينات واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار؟! وإذا كان الإسلام يوافق اليهودية في عبادة الله وحده لا شريك له، وفي الإيمان باليوم الآخر والحساب والجنة والنار، فإنهما يختلفان في أحكام الحلال والحرام، وفي تفاصيل العبادة، في أمور أخرى يطول فيها الكلام ويضيق بها المقام.
الوقفة الثامنة
أورد لوبون في مستهل الفصل الثالث، والموسوم بـ«فتوح العرب»، من الباب الثاني، هذه العبارة: «وكانت دولة الروم التي نهكتها محارباتها لدولة الفرس، والتي كانت تعاني عوامل الانحلال الكثيرة، في دور الانحطاط، ولم تكن غير هيكلٍ نخرٍ يكفي أقل صدمة لتداعيه. وكذلك كانت علائم الانقراض بادية على دولة الفرس التي أوهنتها تلك الحروب أيضًا»(١٩). للأمانة، هذه العبارة سبق أن تكررت، وما زالت تتكرر، على مسامعنا كثيرًا، حتى صدّقها العرب أنفسهم. نعم، لا مشاحة أن الإمبراطوريتين العظيمتين: فارس والروم كانتا تنزفان بسبب الحروب المترادفة التي وقعت بينهما، ولكن هذا لا يعني أنهما كانتا مجرد هيكلين نخرين ينتظران أول هبة ريح حتى يسقطا إلى الأرض! إن هذا القول ينطوي على مبالغة شديدة، والدليل على ذلك أن الروم بعد أن أُخرجوا من الشام ومصر وشمال إفريقيا إلى بيزنطة ظلوا يناجزون المسلمين الحروب دون انقطاع، فمرة يغلبون، ومرة يُغلبون.
ومع اعترافنا المسبق بأن السوس كان ينخر في جسد هاتين الإمبراطوريتين، إلا أن الفضل في تحقيق العرب المسلمين لتلك الانتصارات الكاسحة، لا يرجع إلى انحلال فارس والروم، بقدر ما يرجع بالدرجة الأولى إلى صدق إيمان المسلمين وتعطشهم للشهادة واستهانتهم بالموت، وهي الصفات التي كان الجندي الفارسي والرومي يفتقر إليها.
الوقفة التاسعة
عندما تحدّث لوبون عن أمجاد الحضارة العباسية في بغداد، قال: «بلغت بغداد ذروة الرخاء في عصر بطل رواية ألف ليلة وليلة هارون الرشيد الشهير (786 – 809م)…»(٢٠). هل وصل الحال بعالمنا الكبير لوبون أن يجعل من كتاب خرافي مشحون بحكايات تفوح منها روائح الجنس والخمر والسحر منهلًا يستقي منه صورة الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد (ت: 193هـ/809م)؟! منذ متى كانت كتب الأدب وسيلة موثوقة ومصدرًا أمينًا لاكتساب المعرفة التاريخية؟! بإيجاز شديد، نحن لا نعثر على أي صلة بين الرشيد الذي نجده في عوالم حكايات ألف ليلة وليلة السحرية وبين الرشيد الذي نجده في المصادر التاريخية المعروفة.
لم يكن الرشيد كثير اللهو واللعب، مولعًا بالنساء والملذات، كما جاء في ألف ليلة وليلة، وهي الصورة التي اشتهرت عنه عند الغرب حتى عند كثير من المسلمين مع شديد الأسف، بل كان خليفة حازمًا عاقلًا عظيم السياسة. وعُرف عنه أنه كان يحج عامًا، ويغزو عامًا، وفي عهده الميمون اتسعت رقعة الخلافة، وبرز الإسلام على سائر الأمم، وشاع الأمن، وكثر الخير، وازدهر العلم. وعُرف عن الرشيد أنه كان يجالس العلماء ويأنس بهم، ويسمع المواعظ حتى يلين قلبه ويسيل دمعه.
الوقفة العاشرة
أرجع لوبون قيام الأمير الأموي عبدالرحمن الداخل بن معاوية (ت: 172هـ/788م) ببناء جامع قرطبة إلى سبب غريب، فقال: «ولم يكد عبدالرحمن يقبض على زمام الحكم في إسبانيا حتى أخذ يسعى في حمل العرب على عدّ إسبانيا وطنًا حقيقيًّا لهم، فأنشأ جامع قرطبة الشهير الذي هو من عجائب الدنيا؛ لتحويل أنظار العرب عن مكة…»(٢١). في الواقع نحن لا نعرف من أين جاء لوبون بهذا التفسير العجيب الذي لا نعثر عليه في بطون كتب التاريخ. ولا ندري كيف تخيل لوبون أن يُقدِمَ الأمير عبدالرحمن، المشهور بصقر قريش، أو الداخل، على منع المسلمين من حج بيت الله الحرام بمكة؟! ولنفترض أن عبدالرحمن بنى هذا الجامع ليصرف مسلمي الأندلس عن الحج، فهل يعقل ألا يشق الناس عصا الطاعة ويثوروا عليه؟! زد على ذلك، فمكة لم تكن ملكًا خالصًا لخصوم بني أمية من بني العباس، وإنما هي ملك للمسلمين قاطبة، ولا يستطيع عبدالرحمن، أو غيره من الأمراء أو الملوك، أن يحول بين الناس وبين زيارتهم لبيت الله الذي تهفو إليها قلوبهم وترنو إليه أبصارهم.
والحق أن عبدالرحمن الداخل ليس هو أول من تعرض لهذه التهمة الشنيعة، فقد نال جده الثاني الخليفة عبدالملك بن مروان (ت: 86هـ/705م) حظه منها، وذلك حين اتهمه المؤرخ اليعقوبي -المعروف بميوله الشيعية- بمنع أهل الشام من الحج، وهي فرية باطلة، وتهمة ساقطة، لا تنهض على دليل، ولم نجد من يتابعه عليها. يقول اليعقوبي في تاريخه المشهور: «ومنع عبدالملك أهل الشام من الحج؛ وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم، إذا حجوا، بالبيعة، فلما رأى عبدالملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة، فضجّ الناس، وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام، وهو فرض من الله علينا! فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس، وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام…»(٢٢).
صفوة القول: أردنا من خلال تلك الوقفات الهادئة مع المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون، في كتابه المذكور، إماطة اللثام عن بعض الإشكالات، التي يتصل كثير منها بمسائل عقدية وقليل منها بحقائق تاريخية. وكما سبّقنا القول، فتلك السقطات التي وقع فيها لوبون لا تعبّر –كما نظن– عن سوء سريرته أو خبث طويته، بقدر ما تعبّر في معظمها عن اعتداده بالعقل المجرد في حكمه على الأشياء؛ وهو الأمر الذي أفضى به منذ البداية إلى إنكار ظاهرة الوحي، التي نشأ عنها بالضرورة اعتقاده بأن محمد ابتدع الدين الإسلامي وألّف القرآن الكريم.
هوامش:
(١) لوبون، جوستاف، حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2012م، ص 31.
(٢) لوبون، حضارة، ص 118، 146.
(٣) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (ت: 660هـ/1261م)، مختار الصحاح (بيروت: مكتبة لبنان، د. ت)، ص 292.
(٤) مسعود، جبران، معجم الرائد، ط 7، بيروت: دار العلم للملايين، 1992م، ص 847.
(٥) البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت: 256هـ/870م)، صحيح البخاري، دمشق: دار ابن كثير، 2002م، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم 3215، ص 796.
(٦) انظر مثلًا: زاهد، محمد رشيد، «موقف المستشرقين من الوحي: دارسة تحليلية»، مجلة دراسات، الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، ج 3، ديسمبر 2006م، ص 105 – 114.
(٧) لوبون، حضارة، ص 102.
(٨) لوبون، حضارة، ص 108.
(٩) لوبون، حضارة، ص 112.
(١٠) البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث رقم 4150، ص 1021.
(١١) المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم (صيدا: المكتبة العصرية، 2016م)، ص 333.
(١٢) لوبون، حضارة، ص 112.
(١٣) ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت: 774هـ/1373م)، البداية والنهاية، اعتنى به: حسّان عبدالمنان (عمّان – الرياض: بيت الأفكار الدولية، 2004م)، ج 1: ص 652.
(١٤) لوبون، حضارة، ص 121.
(١٥) بازحول، محمد بن عمر، علم المناسبات في السور والآيات (مكة المكرمة: المكتبة المكية، 2002م)، ص 23.
(١٦) بازحول، علم المناسبات، ص 24 – 25.
(١٧) لوبون، حضارة، ص 125.
(١٨) لوبون، حضارة، ص 122.
(١٩) لوبون، حضارة، ص139.
(٢٠) لوبون، حضارة، ص 187.
(٢١) لوبون، حضارة، لوبون، ص 287.
(٢٢) اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت: نحو 284هـ/897م)، تاريخ اليعقوبي، ط 2 (بيروت: دار صادر، 2010م)، ج 2: ص 261.
خالد السعيد/ الفيصل
Beta feature
