الرعاية في فكر المطران جورج (خضر)
مقدّمة
محاولتي أن أتكلّم على الرعاية في فكر المطران جورج (خضر) ما هي إلاّ محاولة خجولة، لما عنده من معرفة تصعب الإحاطةُ بها وحضور كنسيّ فاعل، جعلاه داعية تجدّد قامت أساساتُه على العودة إلى الينابيع. وإذ يحمل هو التراثَ الحيّ، يمدّه، ليطال إنسان اليوم في أسلوب تقوم فرادته لا على شكل أدبيّ انطبع عليه، لكنّه مجموعة تحدّيات تستوقف مَنْ شاءَ الإصغاء إلى الله، ليجد أنّ هذه الكلمات التي يلقاها تدعوه إلى اليقظة التي تتطلّبها الوقفة أمام الحضرة الإلهيّة وتحضّه على التغيير.
بادئ بدء أقول إنّ هذه المقاربة إلى فكره الرّعائي، على تقصيرها، لا تقتصر على ما عمله أو علّمه – مَنْ نتحدث حول فكره اليوم – خلال أسقفيّته. لكنّها، وعلى قدر الإمكان، ترجع إلى بعض أقوال وأعمال له هي مطلاّت لله بهيّةٌ كانت، منذ بداءة الأربعينات، زادًا للكثيرين ممّن أحبّوا يسوع، وأخلصوا له. وعرفناها نحن نورًا على أوراق لم يُتعبها تقدمُ السنين، بل إنّما السكرُ من حروف طيّبة كالخمر المعتّقة.
الرعاية وكالة أو تكليف، إطارها التعليم والأسرار المنفّذان بالحبّ أي الممتدّان إلى الآخر وخصوصًا إلى الفقراء ، هذه الوجوه الثلاثة: الكلمة والأسرار والفقراء ، كما عبَّر عنها المطران جورج، مُسْتَدَلُّنا في ما نتحدث عن الرعاية في فكره اليوم.
الكلمة
منذ ما يناهز الخمسين سنة دعا شاب يافع الكنيسة الأنطاكيّة إلى “الانتباه إلى الكلمة” الموجودة خصوصًا في الكتاب المقدّس والطقوسيات، وكانت قد اضطرتها الظروفُ من جهة، والخضوعُ للظروف من جهة أخرى، إلى إهمال الكلمة طيلة قرون عدّة. وبقينا – وفق تعبيره – شعبًا أكثرُنا لا يحبّ الله ، ذلك أنّ الآذان ثقلت والقلوب غلظت و”الناس عاشوا حياة باطلة وتعلّقوا بالزَيْف وحالفوا الشرّ وأقاموا قصورًا عنكبوتيّة نسجها لهم خيالُ الشيطان” ، حتى باتوا غير قادرين على أن يسمعوا “أصوات من يلتمس النجاة من الجوع والفقر والجهل”. هو صوت الله، إذًا، وكلمته التي لا يمكن إدراكها من دون إيمان وتوبة تعصف من جديد. وتوالت التذكيراتُ، والصحو زاد، والدعوة هي إلى خدمة الكلمة. يقول: “يجب أن نَقضي معظم وقتنا في خدمة الكلمة” ، وأننا “ما دمنا على عهدنا مع الكلمة فالكنيسة مفتقدة” ، وذهب إلى ما حفظه التراث الحيّ من أنّ الكلمة الإلهيّة (أو التعليمَ المستقيم) هي أحدُ وجوهٍ ثلاثة تكشف حضور السيد بعد ارتفاعه إلى السماء، إذ قال: “إنّ اكتشاف الله هو اكتشاف كلمته” . كيف تقوم المجموعة الأرثوذكسيّة التي عندها كتاب العهد الجديد، والتي هي موصوفة فيه، إلى مستوى هذا الكتاب ، ذلك هو هاجسه وهذا كان مسعاه.
الكلمة الإلهيّة، وفق تعبيره، هي التي تصنع الشعب المبعثر شعبًا إلهيًا ، لأنّ “اللغة – بمعنى التعليم الإلهي، يقول – أيضًا معموديّة” ، ذلك أننا، إذا تقبلناها بالتوبة والحبّ، تعيدنا إلى نقاوة الغسل الأول فنتمكّن من اقتبال الجسد والدم الإلهيّين اللذين هما “الحياة ودوامها” . والكلمة متطلّبة ولها حقوق على محبي يسوع، فقراءتُها قراءةً يوميّة وخصوصًا العيشُ بمقتضياتها أشياء مطلوبة كلُّها من الرعيّة، لأنّه ليس أحدٌ فوق الكلمة ، والشيء الأساس – عنده – هو أن يصبح كلُّ إنسان إنجيلاً آخر . لذلك بقي همُّه الرئيس أن يأتي بـ”الناس ليسمعوا ويستفيقوا”، حتى إذا فعلوا، يقول: “يُضيئون الكون”، هذا ما رآه بسببٍ من “كليّة الكلمة وحقّها على الناس” .
يستعمل المطران جورج، في بعض الأحيان، الموازاةَ بين تناول الكأس وتناول الكلمة، كقوله مثلا: “يتناولون الكلمة الواحدة والكأس الواحدة”، ذلك أنّه عرف أن الإنسان يحيا من القرابين الإلهيّة وبآنٍ من الكلمات الذهبيّة التي تخرج من فم الله، وهذا عنده من تأثّرٍ بأنبياء العهد القديم، وعندهم تناول الكلمة بمعنى أكلها مفادُهُ تبليغُها. لذلك رأى أنّ المعمّدين أنبياءَ العهد الجديد هم المسؤولون عن تبليغ الكلمة، وهذا منطلقُهُ الإصغاءُ إلى الكلمة وقبولُها “بعنفها ومدى تطلّباتها”، فإذا تجمّعوا حولها وأسكرتهم، كما يقول “تنطقهم هي بغير لغة الناس فتتدحرج الألوهة على ألسنتهم فتُحرقهم هي وتُلهب الدنيا بهم وعيونُهم شاخصة إلى هذا الذي يرفعهم بروحه في مواكب الدهور الآتية” . من المعلوم عنده أنّ خدمة الكلمة تحتاج إلى نوع من الرهبانيّة، بمعنى الانكباب على الدرس أو التبتّل فيه، وتاليًا إلى نحت الحياة لتوافق الكلمة. وهذه الخدمة لا تقتصر على نقل الكلمة بمعنى تردادها أو تفسيرها أو توزيعها وعظًا وحسب، وإنما على جعلها “نافذة وملاحقة” حتى يبقى الناس دائمي الالتصاق بالربّ، وهذا يحتاج إلى إيجاد وسائل لضمّهم إلى الله، كما يقول، واستعمالِ الطرق التي أعطاها الله كالأسرار لجعل الناس مرتبطين بالكلمة ويحيون منها.
الإفخارستيّا سرّ الملكوت
من هنا نأتي إلى وجه آخر للكلمة – عنده – يتحقّق بالكليّة في ما اصطُلِح تسميتُهُ في أواخر القرن الأول إفخارستيّا، ذلك أنّ الله الذي ينادي شعبه المبعثر ويدعوه إليه، هو يملك على مطيعي النداء بالحبّ. وهذا ما يقوله عن الكنيسة التي تتحقّق في هذا اللقاء “الكنيسة هي في عبادتها والأسرار انكشاف وجه السيّد في محبّته المذهلة” . والكلمة، أيضا، في اللقاء العرسي مادّة أساسيّة من مواد النجاة، فهي التي تهيّئ النفوس المودودة لتخطب للربّ – وهنا يستعمل تعبيرًا للعلامة أوريجنس – فيتزوجها الربّ في سر الشكر، في تلاقي الدماء، في اتحاد لا يُسبَرُ غورُهُ، كما يُضيف.
صورة العروس، التي تختصّ بالكنيسة في الكتاب المقدس ، يستعملها المطران جورج على أساس تحققّها كليّا في اليوم الأخير ، غير أنّ مذاق العرس – عنده – يتمّ أيضًا الآن وهنا Hic et nunc. فالكنيسة هي بآنٍ الملكوتُ وعتبتُهُ ، وبتعبير له آخر هي: عتبة سرِّ المسيح ، لأنّ “السماء انحدرت إلى الأرض بالمسيح” ، وأُسقطت كلّ مسافة كانت قائمة بين ما هو فوق وما هو تحت، وهذا ما يقوله بشكل قاطع “إنّ الملكوتيّة تمرّ دائما بالراهن” . لذلك جاء خطابُه إلى الرعيّة بأن لا تهمل خلاصها، فنبَّه مَنْ أسماهم بـ”الموسميين” ، وهم الذين لا يشتركون في أسرار الكنيسة إلا في الأعياد الكبرى، أو في ما أسمَوْه هم احتفالات أو مواسم لهم خاصّة ، بأنّ استمرارهم على ما هم عليه يُفقدهم عضويتهم في جسد المسيح، ودعاهم إلى مصالحة مع الكنيسة تكون في الأخير استجابةً لتنازل الله الكلمة وارتضاءً لملكوته.
وبكنيسة واحدة جامعة مقدّسة رسوليّة
وجد، من نجتمع حول فكره اليوم، في كنيسته كلّ تعزية . ورأى أنّ القهر والتفاهة البشريّة لا يمنعانها من أن تكون “موطن البهاء وقداسات مذهلة” . ولذلك قد تفهم محبّته وخدمته لها إذا أتيت من محبّة السيّد والطاعة لوصيّته، فليس جمال الناس أو ثقافاتهم أو غناهم شرطًا لرعايتهم ومحبّتهم بل وصيّةُ الله أو تكليفُه . كلُّ شيء يأتي من الله، وإن كانت الوصيّة الثانية عظمى ومثل الأولى إلا أنّها تأخذ مكانتها وقوة معناها من الوصيّة الأولى. بعد هذا، يقوم العمل في الكنيسة على الإدراك بأنّ أغلب الناس هم دون متطلبات إنجيل يسوع المسيح، وأنّ الله يريدهم أن يعلوا فوق ما هم عليه. هذا ما أشار إليه منذ سنوات، إذ كتب في جريدة النهار فصوَّر هذه الدونيّةَ وتفشياتِها وما لها من تحكّمات قد تؤدي بالصفات الأبديّة إلى أن تكون فقط “تأملا نظريا” . لكنَّ الكنيسة، في فهمه، تبقى تاريخا يمتدّ هو إياه امتداد المسيح الذي، إذ يسكن فيها، يُلهبها إذا فترت ويعيد إليها قلب صباها إذا شاخت ويعود يرضى عنها ويخطُب ودّها بسبب حبّه لها وبسبب هذا الترابط العضوي، بين الإلهي والتاريخي، الذي حدث مرة وإلى الأبد . لذلك رأى أنّ وحدة الكنيسة وجامعيتها وقداستها ورسالتها في العالم هي قرارُ الله المحقّقُ وبآنٍ هي دعوته، فدعاها إلى أن تبقى معا حول الحمل المذبوح لتكون واحدة ، وذكّرها بما أنّها الذاتُ الجامعةُ ، التي نموت إنِ استقللنا عنها وعن ما ورثته، بأنّها “لن تكون جامعة بالمعنى الصحيح ما لم تجتمع فيها الشعوب” ، وأكّد بأنّ القداسة تبدأ من هنا ، وأنّ الكنيسة رسوليّة، ليس فقط بمعنى أنّها تأتي من الرسل وهي واحدة معهم، ولكن بمعنى أنّها رساليّة، ورسالتها تكمن في أن يكون المسيح معروفًا ومحبوبًا في العالم، فحضَّها كي تبقى “طريحا على الدروب المؤدّية إلى الإنسان بكلّ أبعاده” .
الأسقف
ينتصب الأسقف راعيًا للأغنام ضمن هذه الكنيسة-العروس وبالاستناد عليها، وهو يرعى – كما يقول – بالجماعيّة، بالائتلاف، بالتناغم الذي يربطه بالكنيسة كلّها ، في ما يسمّى الوحدة بين الواحد والكلّ. وهذه كلّها لا تَفيد أبدًا الديمقراطيّة بمعناها القانوني الدقيق… ، فإنّ الأسقف مقام من الله… وهو إزاءَ رعيّته وليس فردًا من أفرادها.. ، كما عبّر في مواضع مختلفة. جاء في التراث أنّ الأسقف هو أيقونة المسيح وأنّه السيّدُ وظائفيًا ، يأتي ملاك جبل لبنان من التقليد ذاته ليقول: إنّ الأسقف هو أيقونة الحمل الذبيح، ويؤسّس كلامه على قاعدة الخلاص التي رسمها العهد الجديد عندما صار المسيح كاهنًا لله أبيه بذبيحة الصليب . هذه المذبوحيّة هي التي تعطي الصورة الكاملة لوجه الأسقف في الكنيسة من حيث إنّه سيّد وخادم معًا، وتردّنا إلى قول السيّد المبارك “الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف”. فالأسقف المحبّ الفضيلة والعاشق الحكمة يبذل حياته في خدمة الناس بهدف قداستهم . قداسة الرعيّة هي تكليف الله للأسقف ويؤتى به من أجلها، وهذه يسعى إلى تحقيقها في توليّه الأسرار المقدسة ووعظه بالكلمة على أن لا ينسى الفقراء.
يرى المطران جورج، وبشجاعة كبيرة، أنّ الأسقفيّة تقترن بشروط وأنّ ممارستها تزول بزوال هذه الشروط، هي مُسلَّمة قديمة قال بها القدّيس إيريناوس أسقف ليون، يسترجعها هو فيقول بأن “ليس لأحد امتياز على الجماعة، هكذا يذهب الأسقف بذهاب عقيدته أو أخلاقه، لأنّ المفروض في الراعي “التكلّمُ بكلمة الله والتصرف الحسن وإيمان يقتدى به” (عب 13\7). فإذا لاحظت الجماعة أنّ هذه الأصول غير مرعيّة تحكم أنّها أمست هي بلا رعاية وتسعى إلى من يرشدها إلى الينابيع” . هذا القول يُفضي بنا إلى ملاحظة شيئَيْن، أولُّهما أنّ الأسقف هو معلّمُ الكلمة الإلهيّة وليس تصوّراته الشخصيّة ، عملُهُ أنّه يقود القطيع إلى المراعي الحسنة، ويسهر عليها لكي لا يتنحّى خروفٌ واحد ويتعرّض لخطر افتراس الأسد . هذه الصورة الرمزيّة للرّعاية تجعلنا نتبيّن واحدة من أهم المواهب التي يُعطاها الأسقف وهي أنّه المسؤول الأوّل عن وحدة الرعيّة ، والذي يدفع عنها كلّ تهديد بالانقسام. والشيء الثاني هو أنّ سلوك الأسقف وأخلاقه يجب أن يتطابقا مع الكلمة التي يعلّم، حتى يغدو أيقونة مقدّسة ، فإنّ الرعيّة تخضع للأسقف الأيقونة وتطيعه طاعتَها للسيّد المبارك. وهذا لا يعني، بلا ريب، أنّ الأسقف لا يصغي إلى ما يقوله الروح للكنيسة (رؤيا يوحنا 2: 7) ، فإن كان هو إزاء رعيّته إلاّ أنّ الناس أيضًا، يقول المطران جورج، إزاءه بما يسميه “روح النبوّة” . هذا التعبير الأخير، “روح النبوّة”، يجعل – مَنْ نجتمع حول فكره اليوم – يميّز بين الناس الذين يقوم تجمّعهم على “اللحم والدم”، وبين الذين يخافون الله ويكيّفون حياتهم والإيمانَ الذي بُشِّروا به، فيلازمون حياةَ الشراكة في أسرار الكنيسة ولقاءاتِها بغيةَ اكتساب فكرِها ومناقبيتِها. غير أنّ هذا – عنده – لا يعني أنّ الذين لا ينتمون إلى هذا الوعي ليسوا أعضاء في شعب الله! ولكنه، بكل تأكيد، يعني أنّ الأسقف، لأجل إحقاق حقّ الله، لا يشاور في شؤون الكنيسة سوى “ركيزة الجماعة المعمّدة”، أي الذين دخلوا بكلّ قلبهم وكلّ عقلهم وكلّ قدرتهم في تيار المحبّة الذي يُحييه الروح ويغنيه. يقول المطران جورج في تحديده الشورى بين الراعي والرعيّة بأنها: لا تعني “الفوضى” ، وإنما هي شورى بينه وبين الأتقياء… المصلين المتطهرين… وليس مشاورة لمن يجهل كلّ شيء عن الحياة الروحيّة .
وَحدة في اختلاف وظائف
الوَحدة في جسد المسيح لا يُعطِّلها اختلافُ الوظائف ، يقول: “إنّ كنيستنا مبنيّة على الأساقفة والقسس فيما يحملها الجميع” ، ذلك لأنّ الروح القدس يهب نعمته لكلّ واحد لمنفعة الجميع أو كما يقول بولس الإلهي لـ”بنيان جسد المسيح” ، فلا تعطى موهبة لواحد من أجل نفسه فقط ولكن من أجل الجماعة. لذلك رتَّب الله في كنيسته خدمًا متنوّعة، حتى إنّه لا يستطيع أن يقول أيُّ عضو لآخر لا منفعة لي منك.
الكاهن
يُفرَز الكاهن من بين أعضاء شعب الله الذين يتناغمون بقيادة الروح ويبقى معهم في الانسجام ذاته ولو اختلفت مسؤوليتُهُ . أوّلُ ما يلفتنا في كلام المطران جورج في الكاهن قولُه “الصفات التي طلبت من الأسقف مطلوبة من الكاهن” ، ذلك أنّه لم يُغره الموقف التقليدي – على صحّته – وهو أنّ حضور المسيح والاتحادَ به في الحياة الطقوسيّة يُؤمّنها الكهنة، حتى يَقبل بأن يُقيم الأساقفة القانونيون رسامات لملء الفراغ في الرعايا، وفي أغلب الأحوال الناس مشتّتون “وإيمانهم مهدّد”، خصوصًا وأنّ واقعنا الرعوي كثيرًا ما استَغلته البدع والتيارات المختلفة، ناهيك عن حجم الرعايا وقلة عدد الكهنة. على الرغم من كلّ شيء فإنّ موقفه من اختيار الكهنة للخدمة بقي ثابتًا، إذ يطلب أولاً: كهنةً أنهَوْا دراسة اللاهوت في معهد أرثوذكسي، ويسميهم: “عمودنا الفقري على مستوى المعرفة والتبشير”، ويَخْلُصُ إلى أنّ وجود مثل هذه النوعيّة من الكهنة هو ضروري للرعايا الصغيرة أم الكبيرة .
يصف المطران جورج الكاهنَ بقوله إنّه “المعلّم الضحيّة” ، هذا لأنّ الكاهن هو أيضًا صورة الحمل المذبوح الذي يبذل نفسه عن رعيّته ليقودها إلى الله بطعام السماء وكلماتٍ من نور، ويكشف في كتابه لو حكيت مسرى الطفولة بأنّ الكاهن “ضحيّة” بمعنى “القربان” أيضًا، تتآكله الرعيّة “ليس في خدمة متواصلة يسديها ولكنّها تمضَغُهُ بألسنتها وتدوسه بأقدامها” . ما لا ريب فيه أنّ مَن نتحدّث حول فكره اليوم استطاع أن يقول ويعمل – في هذه السنوات الخمسين – أشياءَ كثيرة في كشف ماهيّة الكاهن ، وفي أمور اختياره وتنشئته الروحيّة والعلميّة وثقافته ومناقبيته وعمله، كما أنّه استطاع تاليًا، في استناده على التراث، أن يؤكّد واقعيّة زواجه وكيف على الرعيّة أن تتعهّده وعائلتَهُ بكرامة حقّ وحبّ كبير. ما هو أساسي في كلّ هذا هو أنّ الكاهن – بالنسبة إليه – “إنسان الكلمة الإلهيّة الموحاة” ، هو “حصرًا وتحديدًا خادم الكلمة” ، يقذفها في نفوس الناس وزمانهم ليتصوّر المسيح فيهم. ويسعى إلى افتقادهم في دنياهم لا ليشاركهم بها بل ليأتي بهم إلى ما هو أبدي ، يُبدّد “قوَّته للمرضى والمعوزين… ” ويقبل الناس جميعًا “بالّلين وكأنّهم أسياده وبالتفسير الهادئ الموصول وكأنّهم أصحاب المعرفة. وذلك كلّ يوم – كما يقول – في الساعات التي يشاؤون وليس له في ذلك فترةُ راحة أو استجمام ليستمع إلى شكاواهم (…) والويلُ له إن استخفّ بواحدة أو استعجل محدّثه! كلّ إنسان محور وجود” .
صعوبات رعائيّة وحلول
يلاحظ المطران جورج أنّ الرعاية الكاملة تعترضها صعوباتٌ عدّة، فالخروف الضائع لم يعد خروفًا واحدًا، كما قال بطريرك الإسكندريّة في زيارته الأخيرة لكنيسة جبيل، ويَلْزَمُنا لإعادة الخراف الناطقة إلى الحظيرة وعيٌ جماعي لجِديّة الالتزام وللبشارة، وتاليًا دعوةُ الحارّين بالروح الذين “ذاقوا حلاوة السيّد” وتجنيدُهم للمساهمة بالخدمة الإكليريكيّة. هذا ما سعى إليه، مَنْ نجتمع حول فكره اليوم، فدعا إلى ما أسماه “فئة ثانية من الكهنة” يخضعون لنوع من الإعداد ليتمكّنوا من الخدمة وينصرفوا إليها “وقد نسمح لهم – كما يقول – بتعاطي أعمالهم الدنيويّة أو بعض من أعمال” ، وأيضًا إلى النظر إلى الشموسيّة كخدمة ملازمة للأسقفيّة أو القسوسيّة وليست بالضرورة “مرتقى أو وعدًا بدرجة أعلى”، ورسم أدوارًا عديدة لعمل الشمامسة في الرعيّة بما ينفع حسن الرعاية ويفيد الناس.
العَلمانيّون، شعب الله
قضيّة العَلمانيين في هذه الكنيسة المشرقيّة كانت منذ ما يناهز الأربع والخمسين سنة، بامتياز، قضيّةَ مَنْ يجمعُنا فكرُه اليوم، فهو الذي أثارها وأطلقها لأنّها قضيّة جسد المسيح الذي يتآلف فيه المؤمنون الذين ينعكس فيهم سرُّ الثالوث القدّوس. فالكنيسة التي هي “استمرارٌ لتجسّد المسيح ووجوده الظاهر” ، كما يقول، الشعب كلُّه فيها “حافظ الإيمان” ، وأنّه (أي الشعب) مع الأساقفة والكهنة “أدوات في سبيل الكنيسة” التي هي “مسرح للمسيح” . قد يعجُز التكلّم عن العَلمانيين وأصالة دورهم في الكنيسة وفرادته ممّا جاد وأغدق في الدقائق المتبقيات، ولكني سأحاول الإطلالة على بعض نواحي فكره لأجل استكمال صورة الرعاية. العَلمانيون رعاة، هذا تكليف برز في أحاديث له هنا وثمة، وذلك لأنّهم يحبّون، يقول: “علّمتني الرعاية (…) بعض الأشياء، ومنها أننا معشرَ الكهنة نَرعى ونُرعى ويَرعانا حبُّ المؤمنين” ، هذا الحبّ هو الخدمة الوحيدة التي تسند إلى المؤمنين جميعًا ويترجمونه هم في كلّ ما يقولون ويعملون، هو أساسًا حبٌّ للسيّدِ وكنيستِهِ وإذا بَطَلَ الحبّ تبطُل، بلا شكّ، الخدمةُ كما يقول في تصوير له: “إنّ العاشق إذا بَطَلَ حبُّه وبقي حائزًا على أمتعة الحبيب تفقد الأمتعة معناها” .
كلّ عضو في الكنيسة – على فرادته – مترابطٌ مع الكلّ بشكل لا يمكن أن تُفصم عراه، وهو تاليًا محتاج إلى الكلّ وينمو باتصاله فيهم وينمون باتصالهم فيه على قدر ما يتّصلون جميعًا برأسهم الذي هو يسوع الربّ. يقول: “ليس في الكنيسة طبقات، ليس في الكنسية من هم فوق ومن هم تحت” ويتابع أنّه “في الكنيسة انتظام” ، هذا الوضوح لرؤيته لـ”الجسم الكنسي” ناله من فهمٍ صحيح لسرّ الإفخارستيّا وهو السرّ الذي يكوّن شعب الله، والذي على أساسه تُحدّد وتُرتّب الحياة الكنسية وما إليها من أعمال أو تنظيم.
في مفهومِهِ العملُ الكنسي يخصّ الجميع، إلاّ أنه، بلا شكّ، يميز بين الذين يلتزمون حقّ الإنجيل ويتعبون لكي تسود كلمة الله على قلوبهم والجميع، وبين الذين تحكمهم شهواتهم وعائلاتهم ويريدون أن يفرضوا أخلاقهم على الكنيسة وحياتها وأعمالها. فمع أنّه يقول: “العلمانيون قائمون تحديدا في الكنيسة وشهادتهم منهم هي “مسحة القدّوس”، ويذهب في قوله إلى أنّهم “لا يفوّضها إليهم أحد…(و)الكنيسة التي هم يشكّلون تطلقهم إلى العالم بلا استئذان أحد.. ” ، غير أنّه يدرك أنّ هذا لا يَعيهِ الجميع، وأنّ المعموديّة “قد تظلّ ماءً” ، وأنّها تاليًا لا تُعطي امتيازًا إلاّ للعملة الحقيقيين الذين قبلوا سيادة الله القدّوس عليهم . وعلى هذا الأساس، أي أساس ولادتنا بالماء والروح التي “لا نخلص – كما يعبّر العلاّمة الإفريقي ترتليانوس – إلاّ إذا بقينا فيها”، يلاحظ المطران جورج أنّ الأسقف يختار الذين ينتمون إلى هذا الوعي، بمساعدة المُخْلِصين ، ليشاركوا في أعمال الكنيسة وخدمها والاهتمام بالأوقاف تنميةً واستثمارًا . ويبقى أنّ غاية كلّ قول وعمل هو مجدُ المسيح وحده الذي لا شيء يوازي شرفَ الانتماء إليه . هذا ما قاله بإلحاحٍ في نشرة “رعيتي” التي تصدر عن دار المطرانيّة عاملاً على توجيه العلمانيين، وخصوصًا العاملين في مجالس الرعايا، وتصحيح الذهنيات المريضة بالقبليّة والعائليّة “التي هي عدوّة الكنيسة”، كما يقول. فإنّ كلّ سعي إلى المسيح وخدمة الناس غير ممكنٍ من دون امتلاك روح الربّ، وهذا ما بيّنه في تحديده لمجالس الرعايا، إذ قال: إنّهم “اجتماع متواضعين نهضويين يملأهم روح المسيح” .
الفقراء وجه المسيح
وبما أنّ “الرعاية لا تقتصر على التعليم – كما يقول – وأنّها في الدرجة الأولى انتباه إلى الآخر في أوضاعه الحياتيّة والانصراف إلى خدمته” ، نأتي إلى الوجه الأخير في حديثنا عن فكره الرّعائي ألا وهو الفقراء.
لعلّ أفضل تعبير بلّغه عن اهتمامه بالفقراء هو “الفقراء جرحه” ، وهو إياه جرح المسيح الدائم، ويعني به “الفقراء والمرضى والمهجَّرين” ، و”الذين لا مأوى لهم ولا طعام وشردهم الظلم” ، “وكلّ طريحي الشقاء والقهر” . الفقراء جرحه، وأما الفقر فقد يكون نعمة ، لأنّه يمكن “أن يصير (الفقر) حالةً ملكوتيّة أي تأهلاً لالتماس الله” ، كما يقول. أمّا الفقراء فهم “إخوة السيّد” بمعنى أنّهم بامتيازٍ وجهُهُ في العالم. هذا هو التراث وهو يمدّه في مواقفه فيقول مثلاً: “كلّ ذبيح إمكان مسيح” وأيضًا هو (أي المسيح) “خبيء الفقر في كلّ حين” و”الساكن في المقهور أبدا” ، وفي ما يوحّده مع المشرَّدين والغرباء يكشف، في كتابه أنطاكية الجديدة، سرَّ الله في انعطافه على الناس إذ يقول “الآخر هو المسيح دائمًا” ، لأنّ الآخر، الذي لغويًا هنا المسيحُ خبرُهُ يُعطينا كلَّ حضور السيّد المبارك الآن وهنا، وتاليًا إذا أحببناه ورعيناه فإننا، بكلّ تأكيد، نفعل ذلك مع المسيح نفسه . كذا كان المنطلق في كلّ التاريخ الخلاصي، فالعلاقة مع الله هي بآنٍ عموديّة وأفقيّة حتى تكتمل علامةُ المسيح التي هي مرقاتنا إليه. من هذا الوعي المتأصّل في التقليد يأتي المطران جورج، ولذلك لا تستغرب عنده أنّه يُعلّي محبّة الفقراء ويجعلها مِحَكَّ كلِّ وعي أو التزام مسيحيَيْن، ممّا يدفعه إلى أن يعظ، في وقت مقبول وغير مقبول، ويكتب ضدّ عيش الإلهيّات على صعيد الإنشاد والشعاع السلوكي على حساب إهمال محبّة الفقراء، وأن يصف المعطي المتهلّل بأنّه “أكثر إدراكًا من لاهوتي جافّ” … أن نتمرّس بمحبّة الآخر وأن نعمل لكي يكون عظيما على جميع المستويات التي يطلبها الإنجيل يعني أن نمدّ الحياة الأسراريّة، والتعليم الإلهي الذي هو في معناه الأخير رعاية، إلى حياتنا اليوميّة لتكون هي حياتَنا.
في جلسة له مع بعض زواره، على شرفته في دار المطرانيّة التي هي مَحجّ لمحبي الحقّ وطالبي الحكمة، كان يردّد قولا للقدّيس يوحنا الذهبي الفم، وهو: بعد مذبح الرّبّ هناك مذبح الفقير ، وأردف سائلا: لماذا مذبح الفقير؟ وأجاب من دون انتظار: لأنه، عند قدّيسنا، على مذبح الفقير أيضا يحلّ الروح القدس. نجد لهذا الكلام صدىً عنده، إذ يقول “القُدّاس (…) فعل بدء المجتمع الجديد الذي تسوده المشاركة. المطلب الاجتماعي يطلع عندنا من العبادة. وما كانت العبادة تتمّ في الهيكل إلا لتنقل منه إلى هيكل المجتمع ليتجلّى الكون. ” وفي موضع آخر يقول: “الاشتراك في الخبز الواحد (…) يحتّم علينا المشاركة في حاجات القدّيسين” . هذا المصطلح الأخير “حاجات القدّيسين” مصطلح معروف في كتابات بولس الرسول وعنده يعني تحديدًا حاجات الفقراء، وخصوصًا فقراء كنيسة أورشليم، المعوزين منهم والكهنة الذين طردتهم السلطات اليهوديّة من خدمة الهيكل لأجل اعتناقهم البشارة الجديدة. على هذا التعليم القوي يؤسّس المطران جورج خطابه إلى الرعيّة فيقول بالقوة ذاتها: “المال هو لله أي للفقير والكاهن والمعوز” .
لا شكّ في أنّ اهتمامه بالإخوة الصغار على أساس أنّهم سادة القوم وأسياد الكنيسة لم يجعله يُقصي خطابه عن الآخرين، لأنّ الأسقف الراعي يهتمّ لأمر الخراف جميعا، وما يدلّ على محبته للأغنياء واهتمامه بخلاصهم هو وعظهم وحثّهم، حتى ولو اضطرّ إلى توبيخهم ، كي يعلّوا الإخوة الصغار لأنّهم جميعًا أبناء آب واحد. ولكي لا يسقط أحد في الجهل، حسب قول الإنجيل الشريف ، دعا ذوي الأموال إلى أن يكون شأنهم الأوّل هو “ما يتعلق باللُقْمَة والمدرسة والطبابة والدواء وما يؤثّر في حياة المحرومين ويرفعهم إلى الأعلى بالكرامة الحقّ والحرّيّة الحقّ” . وقال إنّ برهان المحبّة، قبل الشهادة، هو وحده “العطاء المادي” ، وكشف رؤية الكنيسة الأرثوذكسيّة لجهة ما يتعلق بمفهوم الملكيّة، إذ قال هي “قيمومة وعُهْدَةُ ملكِ الله، في خدمة الإنسانيّة كلّها” ، فـ”المال وكالة وائتمان… ” هكذا علّم كبار الآباء فأتى منهم ودعا إلى الاستقلال عن المال عن طريق إعطائه ، وإلى تبديده على المساكين لأنّه “لهم شرعا” ، حتى قلب كلّ المقاييس البشريّة عندما قال “غنانا ليس بمال نجمعه بل بمال ننفقه” .
لقد أدرك، مَنْ نجتمع حول فكره اليوم، أنّ العطاء الذي فرحُهُ “أعظمُ وهجًا من فرح الأخذ” ليس هو عملَ أفراد ميسورين في الرعيّة وحسب، ولا يمكنه أن يُكْمِل المحبّة إن لم يتّخذ طابع العمل الجماعي. لذلك دعا كلّ رعيّة لأن تتعاضد وتتساند، يقول “لقد آن الأوان لكي نتعلّم أنّ الأرثوذكسيين مسؤولون بعضهم عن بعض” ، وأنّه “في الأصل فقراء كلّ رعيّة في مسؤوليّة الرعيّة” فأشار بذلك إلى الذي ما انفكّ يحاول الوصول إليه منذ أن وطئت قدماه أرضَ جبلِ لبنان أسقفًا، وهو أن تشعر كلّ رعيّة بأنّها “جزء من كلّ” والكلّ – بالنسبة إليه – “هو كنيسة المسيح المحقّقة في الأبرشيّة والجامعة بالروح القدس رعاياها في جسد المسيح الواحد” .
إنّ الآخر موجود أمامنا وفي حقيقته الأخيرة هو أيُّ آخر مهما كان دينه أو جنسه ، هذا هو مدى فكره، وإن محبته ومساندته ماديًا واجب إلهي، لأنّ “كلّ محبّة لا تنتهي بالعطاء المادي هي محبّة نفاقيّة” ، كما يعبّر.
الأوقاف والمؤسسات
يأتي كلامُه في الوقف الذي هو “فكرة الملك الجماعي” من هذا الحبّ الكبير الذي حفظته الكنيسة لخدّام هيكلها وللمحتاجين، لأنّها خشيت بُخْلَ البُخلاء فحبست بيع الوقف – كما يقول – ليبقى للفقراء شيء من الأقدمين إن لم يقم المعاصرون بما عليهم من واجب تجاه الضعاف . في الخمسينات وما قبلها جاء تركيزه الأساس على “رعاية النفوس”، وهو الأمر الذي كان المسؤولون في الكنيسة مصروفين عنه في سبيل مشاريع زمنيّة وجدت لخدمة هذه النفوس . وقد وصف الأوقاف والمؤسسات حينها بأنّها “الوسائل المصطنعة”، وقد أدركنا غيرة عنده وصلت إلى حَدِّ الحدّة، والغيرة عند الأنبياء إلهيّة، حتى يكون الله محبوبًا في مُهْمَلي الأرض، ولذلك ما كان همّه في الأصل إهمال المؤسسات أو الأوقاف وإنما التذكير بأنّ “ديانة الروح (…) تعني الحريّة من المؤسسة بالبقاء فيها” ، وبأنّه “إذا استقام الحجر فلكي يكون مأوى لفقراء الأرض الذين أحبهم (الله) وللكلمة” . ولذلك رأى أنّ من واجبه الأوّل تذكير من وجد في هذه الوسائل إفادة ما للعمل الكنسي، أنّ محبي يسوع “إن اشرفوا على الأوقاف فهم لا يَتيهون فيها ولا يذيبون الكنيسة في حدودها ولا يخونون الإنجيل في معالجتها” . وهذا ما بقي ثابتًا في تعليمه إلى اليوم، فالمؤسسات “تنفع – كما يقول – إذا رُبِطَتْ بالرسالة الإنجيليّة” والإنجيل، بالنسبة إليه، هو أولاً “إنجيل الفقراء” .
خاتمة
مررنا على غيض من فيض، وكنا نتنقّل بين واقع بشري ورؤية إلهيّة، فإن كانت الرؤية حقيقةً كاملةً تُعطى واقعًا في اليوم الأخير، إلاّ أنّ هناك بشرًا أُعطوا أن يحيوا ويكرسوا أنفسهم لكي تكون هذه الرؤية واقعًا منذ الآن.
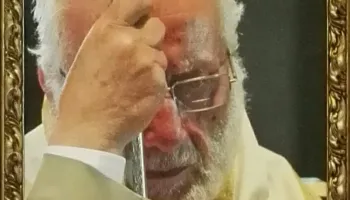
اترك تعليقاً